إنها رحلة طويلة لا نهاية لها وقد لا تنجح في إنقاذ حياة الأسرة الموجودة في مؤخرة الشاحنة. يسرع بهم سائق الشاحنة مباشرةً من موقع الانفجار الذي أصابهم في حقل الألغام، متجهاً إلى أقرب مستشفى في المخا. مرت ثلاث ساعات والأسرة في حاجة إلى الرعاية الطبية.
هنا اليمن، وهنا أصيبت هذه الأسرة جراء انفجار أحد الألغام الأرضية التي تركها الجيش لتنفجر بالمدنيين.
تقول أنييس فارين-ليكا التي أتت ثلاث مرات إلى اليمن هذه السنة مع أطباء بلا حدود: “لقد زرعوا الألغام في جميع أرجاء هذا المكان، في الحقول وعلى الطرقات
ومن يلعب في الحقول؟ الأطفال بالطبع. من يعمل في الأراضي؟ أهاليهم. ولهذا فإن أسراً بأكلمها غير قادرة على زراعة الأراضي وحصادها، وإن حاولت ذلك فستكون عرضةً لانفجار الألغام. لقد أدى هذا إلى أجيالٍ بأكملها تعاني من بتر الأطراف”.
ما إن لمح السائق علم أطباء بلا حدود حتى أسرع تلقائياً. كانت الشاحنة تقذف الحصى وهي تشق طريقها، قبل أن تعلو أصوات مكابحها بحزم وهي تتوقف في حرم المستشفى. بعدها سُمع صوت جرسٍ يدق.
“يقرع هذا الجرس كلما وصلتنا حالة طارئة. وهو يبعث على عدم الراحة، يجعلك تشعر بالقلق لأنك لا تدري ما الآتي”.يهرع رجال ونساء مرتدين ملابس طبية ذات لون أخضر باهت إلى الشاحنة.
ينتصب في مؤخرة المركبة رشاشٌ مروّع لا يتناسب حجمة وقوته مع قوام الرجل الذي يجلس خلفه. كان يرتدي على رأسه وشاحاً مغطى بالرمال وكان مصدوماً تماماً.
بدأ الطاقم بإنزال أربع جثث فيما كانت سحابة الغبار التي خلفتها الشاحنة بوصولها الذي أعلنه صوتٌ يصم الأذان، لا تزال تسبح في الهواء. أُنزِل البالغان أولاً، ثم وضعا في أكياس مخصصة للجثث وتوجه بهما الطاقم فوراً إلى غرفة حفظ الجثث، إذ لم يعد ثمة ما يمكن فعله.
“الأخوان اللذان تتراوح أعمارهما بين خمسة إلى عشرة أعوام ليسا ميتين. أحدهما حيّ، لكنّ الآخر يعاني من نوبات تشنج مقلقة. ”لا يمكنه السيطرة عليها. يبدو صغيراً داخل غرفة الطوارئ التي تبدو عملاقة بالمقارنة معه. جسده بالكامل يرتعش.
ثمة فجوة صغيرة في جمجمته لا تبدو لي وكأنها خطيرة، لكن الشظايا قد اخترقتها. كانت الفجوة التي خلفتها صغيرة جداً لكنها أحدثت أضراراً جسيمةً داخل الرأس.
قد يعتقد المرء أنها مجرد شظية صغيرة، لكن ليس لدينا في واقع الأمر أدنى فكرة. في الحقيقة، لا يمكننا أن نجرى له تصويراً طبقياً محورياً لأنه ليس لدينا جهاز تصوير في المخا”.
يجب نقل الطفل إلى المستشفى في عدن، تلك المدينة الساحلية الكبيرة التي تقع في جنوب اليمن. تبعد عدن حوالي ست ساعات بالسيارة وهذا قد يزيد من المخاطر على حياة المريض.
“نرسله إلى هناك دون أن تكون لدينا أدنى فكرة عمّا سيحل به. هذا أمرٌ يتكرر كثيراً وهذه هي الحال هنا”.
حياتنا في مستشفى المخا متوقفة على صوت الجرس الذي لا ترافقه سوى معلومات قليلة وتتلوه نفحات من الهواء الذي ينساب حين يُفتح باب خيمة العمليات ويتخلله هدير نيران المدفعية.
تعتبر أنييس المصير المجهول الذي ينتظر هذه الأسرة قصةً مهمةً لا بد من أن يسمعها الجميع، لأن الحرب في اليمن صراعٌ يجري خلف أبواب موصدة.
فمنذ سنة 2015 والحكومة اليمنية، مدعومةً بتحالف دولي تقوده السعودية والإمارات، تحاول دفع المتمردين الحوثيين إلى الشمال
وهذه ليست إلا حرباً أخرى من الحروب التي يعيشها شباب هذه البلد الذين لم يعرفوا في حياتهم سوى فترات قصيرة من السلام الذي تخلل تلك الحروب.
لكن وحشية هذه الحرب تبقى خفيةً في ظلّ القيود الصارمة المفروضة على المعلومات والسفر والتنقل وإمكانية الوصول، وهذا لا يقتصر على الصحفيين إنما يشمل كذلك منظمات الإغاثة
وبالتالي فإن أية أخبار حول الحرب قد تتسرب إلى خارج البلاد تكون مشوهة وملطخةً بالدعاية التي تديرها مختلف أطراف النزاع.
تعمل المستشفيات على علاج المقاتلين وكذلك المدنيين، ولهذا فقد أضحت نافذة تطل على ما يجري في بلد يدفع أهلها ثمن حربٍ لا طائل لهم منها في أغلب الأحيان.
تهتز الطائرة الصغيرة ذات الستة عشر مقعداً بعنفٍ لحظة ملامسة عجلاتها أرض مطار صنعاء.
أقلعت الطائرة التي استأجرتها منظمة أطباء بلا حدود من جيبوتي التي تبعد بضعة مئات من الكيلومترات عن العاصمة اليمنية التي تمثل بوابة العبور الوحيدة إلى شمال البلاد.
لا يرى المرء في مطار صنعاء أرتالاً من الطائرات تهبط وتقلع. كما لا توجد أرتال ملتوية من عربات حمل الحقائب أو حشود من الناس الذين ينتظرون بفارغ الصبر إقلاع رحلاتهم أو وصول زوارهم
تقول أنييس وهي تستحضر بذاكرتها: “حين تهبط في المطار ترى هياكل لطائرات عسكرية ومدنية على جانبي المدرج”.
كان المطار قبل الحرب يعج بالناس والطائرات، لكنه بات اليوم مكاناً مقفراً. “ثمة نافذة استقبال يجلس في جانبها الآخر رجل، وهناك قاعات ضخمة خاوية تماماً وقد بدأت تتداعى كلياً. المكان بأسره متهالك.
يمكنك أن ترى الأسقف وقد تدلت في بعض أجزاء المبنى. لا شيء في مكانه. تدرك عند وصولك بأنك تهم لدخول بلدٍ لا تسير أموره على ما يرام”.
حاله كحال باقي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد تعرض مطار صنعاء على مدار خمس سنوات تقريباً وبشكل منتظم لضرباتٍ جويةٍ على يد قوات التحالف الدولي.
الحوثيون في الأساس من المناطق الشمالية الغربية لليمن وهم جماعة تعرضت لتهميش الحكومة. حمل الحوثيون السلاح وبدؤوا يتقدمون جنوباً، خارج حدود مناطقهم
إلى أن سيطروا في سبتمبر/أيلول 2014 على العاصمة صنعاء، ثما حاولوا في مارس/آذار 2015 السيطرة على مدينة عدن التي تعد أكبر ميناء في البلاد.
عندها شن التحالف الدولي الذي تقوده السعودية والذي يعارض الحوثيين حملةَ ضربات جوية.
“ثم في أول ليلة لك، تبدأ بسماع أصوات الطائرات وهي تحلق، ثم تبدأ بإسقاط القنابل. تفكر في نفسك ’آه، حسن. ثمة أمر ما يجري هنا. هناك قنابل كبيرة تسقط‘. بعدها يهتز البيت وتشعر أنها بداية لشيء ما خطير يحدث في تلك اللحظة”.
وصلت منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود ناتالي روبرتس أول مرة إلى اليمن في أواسط عام 2015.“حين تكون في صنعاء وتسمع انفجار القنابل حولك، تبدأ أخيراً بالتفكير في نفسك ’هل يقصفون حقاً أهدافاً عسكرية مشروعة؟‘.
كما تقول في نفسك ’حسن، هذه مدينة كبيرة ومزدحمة، فكيف لهم أن يحددوا بدقة الأهداف العسكرية؟‘. وكلما اتجهت شمالاً يزداد وضوح ما يجري، حيث تدرك أن لا دقة في عملية الاستهداف،
وإن كانت دقيقةً فهم لا يفعلونها بالشكل الصحيح، لأنه كلما اتجهت شمالاً بعيداً عن صنعاء كلما زاد تضرر المدنيين الذين تراهم جراء القصف”.
تجلس ناتالي في المقعد الأمامي لمركبة مخصصة للطرقات الوعرة وهي في طريقها إلى صعدة، وهي المعقل التاريخي للحوثيين الذين أعلنهم التحالف عدواً عندما اندلعت الحرب.
وهناك، يُعتبر الناس الذي لم يغادروا ولا يزالون في المدينة أهدافاً مشروعة. فقد حوصر سكان المدينة جراء الضربات الجوية.
تتناثر الحجارة على طول الطريق وليس هناك إلا علامات قليلة على وجود الحياة. تتفاجأ بين الفينة والأخرى بمجموعة من اللاجئين الإريتريين والإثيوبيين وهم يسيرون -ربما رغماً عنهم- باتجاه بعضٍ من أخطر المناطق.
كما يزداد وضوح الدمار الذي خلفته الضربات الجوية كلما اتجهت شمالاً.
“تلاحظ وجود مجموعة من الجسور المتعاقبة التي كانت كلها مدمرة عند وصولي، رغم أنه لم يكن قد مضى حينها على بدء القصف سوى بضعة أشهر. يمكنك كذلك أن ترى على الطرقات الكثير من الشاحنات التي تعرضت للقصف، وبالأخص شاحنات نقل الغذاء.
كانت هناك بالتحديد شاحنة قد تعرضت للقصف وكان الجزء الأعنف منه قد طال الخراف التي كانت تقلها. ولهذا كانت هناك الكثير من الخراف النافقة على الطريق.
لم يكن قد مضى وقت طويل على قصفها حين عبرتُ من هناك للمرة الأول وكان الدخان لا يزال يتصاعد والخراف تحترق. لقد كان مشهداً كئيباً جداً”.
ما من شيء وما من أحد في مأمن من الضربات الجوية... أعراس وجنازات ومدارس وأسواق ومحطات وقود. يرفض الناس قيادة الشاحنات المحملة بالأغذية لأنها هي الأخرى هدف للضربات الجوية.
كما ترى ناتالي المخاطر التي يتعين على سيارات الإسعاف أن تخوضها في المنطقة.لا يمكن أن تحيد عن الطريق. فأنت تسير على سفح جبل وما من مهرب أمامك لو أنهم قرروا استهدافك.
كنت أتلقى اتصالات هاتفية في الصباح الباكر. حيث أتلقى اتصالاً من إحدى الفرق من موقع آخر ليخبرونني: “لدينا مريض على وشك الموت. نريد نقله لكن الطائرات تحلق في المكان، ماذا عسانا نفعل؟‘
أقول لهم ’لا أدري‘. عليك أن تشرح للمريض وأسرته بأنه سيموت لو بقي هناك، كما أنه قد يلقى حتفه لو صعد في سيارة الإسعاف”.
إن كان لدى المرء أية شكوك حيال شدة القصف فإنها تتلاشى لحظة الوصول إلى صعدة. كانت المباني القائمة على جانبي الطريق قد انهارت كقطع الدومينو.
“كم كانت مذهلةً سرعة تدميرها. لا بد وأن هذا حدث في غضون شهرين. فقد كانت البيوت والمحال مدمرة وكانت الأنقاض المتداعية تملأ العديد من الشوارع. وهذا يبعث في النفس خوفاً شديداً.
قضينا الليل في المستشفى الواقع في مدينة صعدة وكان الجميع يقولون لي ’ستكونين بخير لأن المستشفيات على ما يرام‘. ولهذا قررنا قضاء الليلة في المستشفى”.
وكان عدد القنابل التي ألقيت على المدينة يحمل دلالات رمزية خاصةً وأن للمدينة قيمة رمزية بالنسبة للمتمردين. أما الدمار في باقي أنحاء البلاد فلم يكن بالقدر ذاته من التركيز.
لم تعاني مدينة عدن الساحلية الواقعة في أقصى جنوب البلاد من الضربات الجوية بالقدر ذاته. فقد كانت العملية التي نفذها التحالف لاستعادة السيطرة عليها سريعة بعد أن دفعت قوات التحالف بالحوثيين قليلاً نحو الشمال، حيث باتت خطوط القتال في محيط تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن.
كانت تعز فيما مضى مركزاً ثقافياً وصناعياً، لكنها باتت تحت حصار تفرضه جميع أطراف النزاع. ويعيش سكانها منذ أشهر عديدة في عزلةٍ عن العالم الخارجي.
كانت الإمدادات تصلها سنة 2016 ليلاً وذلك تجنباً لنيران القناصة، علماً أن نقلها كان يتم سيراً على الأقدام، مروراً بالجبال التي تقبع المدينة بين سفوحها.
هكذا نجح منسق الطوارئ تييري دوران في الوصول إليها أوائل عام 2016.
“علمت بهذا لأن الجراحين والأشخاص الذين وصلوا إلى عدن بعد مسيرهم عبر الجبال قادمين من تعز، كانوا يبكون وهم يرونني صوراً مريعة حقاً لشباب يعانون من إصابات بليغة وقد برزت أحشاؤهم خارج أجسادهم. إنها صور تهزّ أي شخص.
لم يكن قد تبقّ لديهم شيء. لم يكن لديهم أكسجين ولا أي شيء آخر. ولهذا لم يكن في وسعهم فعل أي شيء. معظم المستشفيات إما مقفلة أو غير قادرة على إجراء عمليات جراحية”.
يتنفس تييري بصعوبة على ارتفاع 2,500 متر عن سطح البحر. تصل أخيراً قافلة الحمير والجمال والرجال إلى المدينة التي تتعرض بانتظام لقصف ليلي. “
“هاتفني أحدهم قائلاً ’يبدو أن المستشفى قد تعرض للقصف الليلة الماضية‘. ولهذا ذهبت إلى هناك صبيحة اليوم التالي. رأيت المدير وقلت له
’سمعت بأنكم تعرضتم للقصف ليلة أمس‘. علا ضحك الرجل وقال ’أجل، للمرة الستين‘.”
تمتلئ واجهة المستشفى القائم في تعز بثقوب خلفتها أعيرة نارية وصواريخ وقذائف هاون. “لكننا معتادون على هذا. ولم نعد نعمل في أيّ من الطوابق العلوية
بل يقتصر عملنا على القبو والطابق الأرضي”. لقد قللوا عدد الأسرّة إلى حوالي 100 سرير، علماً أن عددها كان يبلغ سابقاً 600 سرير.
مستشفيات اليمن أهداف، حالها كحال أي مكان آخر. فقد تعرضت مرافق أطباء بلا حدود للهجوم ست مرات منذ بدء النزاع، هذا عدا عن الأضرار التي كانت قد طالت المراكز الصحية قبل ذلك.
“حين يقصفون مستشفى فهم لا يؤذون بالضرورة عدداً كبيراً من الناس وهذا يعتمد على عدد الناس المتواجدين في المستشفى، غير أنهم يقضون على إمكانية إنقاذ حياة الناس بعد ذلك.
إذ يعد النظام الصحي من أهم أعمدة البنى التحتية الاجتماعية، وإن أردت القضاء على الناس فعليك بمهاجمة النظام الصحي”.
أودت الحرب بحياة ما لا يقل عن 91,000 شخص وخلفت أعداداً لا تحصى من الجرحى. لا يقتصر الضحايا على الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي
بل هناك أيضاً الألغام التي زرعها الحوثيون قرب خطوط القتال في جنوب غربي البلاد.
تعتبر مدينة الحديدة الساحلية الواقعة في غرب البلاد أهم ميناء استراتيجي لليمن على البحر الأحمر. وقد عانت هذه المدينة أيضاً خلال هجوم 2018، حيث شهدت توغل قوات برية وضربات جوية مكثفة نفذها التحالف.
تقول أنييس التي ذهبت إلى المنطقة بعد مرور بضعة أشهر: “رأينا منذ بداية 2018 وحتى يونيو/حزيران، تقدم قوات التحالف على طول الجبهة الجنوبية الممتدة من المنطقة المتاخمة لتعز باتجاه المخا والحديدة
وقد دفعنا هذا الهجوم الذي شمل قواتٍ بريةً وضرباتٍ جويةً واسعة إلى بدء عملياتنا في المخا في شهر أغسطس/آب ومن ثم في الحديدة”.
تفتتح منظمة أطباء بلا حدود مشروعين جديدين أحدهما على خطوط القتال في الحديدة والآخر في المخا، وذلك لتقدم من خلالهما الرعاية الطبية للناس العالقين جراء القتال الدائر في الجنوب.
فعلى بعد 120 كيلومتراً إلى الجنوب، تقع مدينة المخا الساحلية التي تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي كان وبالاً عليها. في منتصف الطريق الوحيد الذي يصل بين الحديدة وعدن.
يمر الطريق عبر منطقة صحراوية واسعة تقع على امتداد البحر الأحمر. وهناك لا يصادف العابر سوى بعض القرى الصغيرة وحفنة من الدبابات المحترقة والقوارب الصدئة. المكان يخلو من أي شيء آخر.
“لكن حين نقول أن المكان خالٍ فهذا ليس مجرد تعبير مجازي. إذ لا يوجد حقاً أي شيء ما عدا الطريق. ولهذا إن كنت مصاباً بفقر الدم على سبيل المثال وجرحت إصبع يدك الصغرى، فلن تنجو. إنها صحراء طبية بكل معنى الكلمة”.
خلال بضعة أسابيع، أنشأت المنظمة في مدينة المخا مستشفى مكوناً من خيام وسرعان ما بدأ المرضى يتقاطرون إليه: نساءٌ لوضع مواليدهن، وجرحى الحرب الذين غالباً ما يكونون ضحايا الألغام الأرضية. يستقبل المستشفى أعداداً كبيرة من الحالات الطارئة، غير أن المرضى يصلون بعد فوات الأوان.
يقول الجراح بيرنارد ليميناجيه: “الألغام هي الأكثر قسوةً وعبثيةً. الألغام المضادة للأفراد والألعاب المفخخة التي ألقاها السوفييت خلال الحرب على أفغانستان كي يلتقطها الأطفال.
لا أعلم إن كانت الألغام الموجودة في اليمن قد زُرعت لاستهداف المدنيين عن عمد. لست متأكداً لكنها على الأغلب لوقف تقدم المقاتلين.
لكن هذه الألغام المدفونة تحت الأرض تنفجر. والأكثر تضرراً بها هم الأطفال، ذلك لأنهم في كل مكان”.
يرى بيرنارد الكثير من المدنيين في غرفة العمليات. “تؤثر الحرب على جميع الناس بمختلف أعمارهم، وتلحق الضرر بالجميع. لا يقتصر عملنا على علاج الناس من عمر 7 إلى 77 عاماً، إذ أننا عالجنا طفلاً بعمر 7 أشهر وعجوزاً بعمر 107 أعوام.
ربما ليس 107 بل أعتقد 103، لكنه كان قد بلغ قرناً من العمر. كان الطفل ابن السبعة أشهر قد أصيب بطلق ناري في البطن اخترق معدته.
كان جرحاً خطيراً جداً لأن طلقة البندقية الروسية تلحق أضراراً بالغة برضيع عمره 7 أشهر. لكنه نجا. أما المسنّ الذي تجاوز عمره المئة عام،وأؤكد بأنه تجاوز المئة سنة،
فقد ولد في عهد الإمبراطورية العثمانية. لا نرى كثيراً من المرضى الذين ولدوا خلال حكم العثمانيين
وكان هذا المسن الذي تجاوز المئة عام قد أصيب بشظايا لكنها لم تكن خطيرة، وقد عاد إلى بيته بعد بضعة أيام”.
يعاني كثير من المرضى من إصابات بالشظايا، وهي شظايا صغيرة ناجمة عن انفجار القنابل وتخلف أضراراً يصعب تقييمها. من الأسلم أحياناً أن تُترَك داخل الجسم كي تتعافى الأنسجة المحيطة بها.
لكن العواقب تكون وخيمة على من يكون قريباً من الألغام حين تنفجر.
“ثمة الكثير من عمليات بتر الأطراف. وهي مشكلة للجراحين الذين عليهم اتخاذ القرار بإجراء البتر أم لا. عليهم أن يكونوا على علم بفرص تعافي المريض وما إن كان الطرف سيستعيد وظيفته.
ثم يتعين عليهم إقناع كل من المريض وأسرته بهذا. الأمر في غاية الصعوبة لأننا فوق كل هذا لا نجيد اللغة المحلية. يعتقدون بأننا أطباء بلا حدود، بكل ما نمتلكه من موارد، لا بد قادرون على تجنب عملية البتر”.
يمثل بتر الأطراف العلامة الأوضح على الكلفة التي يتحملها المدنيون في هذه الحرب. فالأضرار التي تخلفها الألغام لا تقف عند الإصابات والجراح التي تتسبب بها،
إنما تعيق كذلك الناس عن التحرك بحرية وزراعة أراضيهم وحصادها لإطعام أنفسهم.
تتكشف بشاعة هذه المشكلة بكل تفاصيلها على الطريق المؤدية من المخا إلى تعز. فهي تمر عبر أراضٍ قاحلة
ترى فيها أعداداً لا تحصى من الأكياس البلاستيكية العالقة على أغصان الشجيرات الصغيرة النامية فوق الكثبان الرملية. يقوم سائق المركبة التي تقل أنييس بتفحص جانبي الطريق.
ويتأنى في قيادته كي يبقى ضمن مسار قد خضع لعملية نزع الألغام وتحدده حجارة صغيرة مصبوغة باللون الأحمر.
“ستبقى هذه المشكلة على حالها بعد 10 و20 و30 سنة، ولن تتغير الحال لأن الجيش ينفذ حالياً عمليات نزع الألغام مستعيناً بجنود متخصصين في هذا.
لكن عملهم لا يشمل سوى المناطق التي تهمهم والتي تتلخص في الطرقات الرئيسية، ليس إلا.
لا توجد سوى عمليات محدودة لنزع الألغام في المناطق المدنية، وما من أحد ينزع الألغام من الحقول.
ولا تزال هذه الألغام تنفجر في المدنيين الذين لا يستطيعون زراعة أراضيهم أساساً. وهذه مشكلة لن تختفي قريباً”.
تدمر القنابل الأبنية وتحصد الضحايا. لكن عواقبها الأقل وضوحاً هي العواقب غير المباشرة والتراكمية
حيث يؤدي تدمير الطرقات والجسور والمستشفيات إلى تداعي النسيج الاجتماعي والاقتصادي في منطقة بأسرها. إذ تشح الموارد أو يصبح تأمينها أمراً صعب المنال.
تتذكر أنييس فتقول: “حين تغادر صنعاء ترى أرتالاً من السيارات وقد اصطفت على مد النظر.
تمر برتلٍ من السيارات التي اصطفت للتزود بالوقود. ينتظر بعض الناس يوماً أو يومين أو حتى ثلاثة أيام لملء خزانات سياراتهم لقاء أسعار لا تعقل”.
يصبح نقل المرضى وجرحى الحرب قضية اقتصادية. “النقل مكلفة للغاية. يأتي الناس في اللحظة الأخيرة
لأنهم يقولون في أنفسهم ’لننتظر ونرى. الطفل مريض لكنه يبدو على ما يرام، وليس لدينا المال. لننتظر قليلاً‘”.
يموت الناس في اليمن لأنهم يتأخرون في الذهاب إلى المستشفى أو لا يملكون المال لدفع تكاليف النقل. وهذا أمرٌ تراه ناتالي كثيراً.
“قد توافيهم المنية قبل أن يصلوا، وعندها لا يكون في وسعنا فعل أي شيء. وإن وصلوا بسرعة فإن علاجهم يعتمد على شدة إصابتهم.
لكن مع صعوبات تأمين النقل للذين لم يصابوا بجروح، فهناك وقت يضيع قبل تأمين المال اللازم أو إيجاد من يقلهم”.
“رأينا الكثير من الأطفال الصغار يموتون نتيجةً لأمراض يمكن تجنبها وعلاجها بالمضادات الحيوية مثلاً.
يعاني المواليد الجدد من مشاكل محددة، مثل أن لا تتمكن الأم أحياناً من إطعام رضيعها، فتجدها تنتظر وتنتظر قبل أن تأتينا بالطفل، لكن الوصول إلى المستشفى يستغرق وقتاً،
ولهذا يفارق الطفل الحياة خلال نصف ساعة من وصوله لأنه لا يسعنا فعل الكثير وقتها، لأن الأوان يكون قد فات”.
ترى فرق أطباء بلا حدود أيضاً عودة ظهور أمراض كانت قد اختفت من اليمن، وهذا إنما يدل على تدهور النظام الصحي.
تفشت الكوليرا في البلاد سنة 2016 وحين وصل نائب رئيس قسم الطوارئ غسان أبو شعر إلى اليمن في 2017، كان الوضع قد استقر كما يبدو
إلى حد أن خطط الطوارئ التي وضعها فريقه للأشهر المقبلة نادراً ما جاءت على ذكر الكوليرا.
ذلك إلى حين... “أبلغ القائمون على مشروعٍ في خمر، في شمال البلاد، عن وجود إصابتين محتملتين بالكوليرا. زاد العدد في اليوم التالي من اثنين إلى ستة”.
جرى عزل مرضى الكوليرا في مستشفى خمر. لكن وحدة العزل كانت قد امتلأت في اليوم الثالث وتم تحويل خيمة كبيرة مجاورة إلى منطقة للعلاج. بعدها تحولت المدرسة بأكلمها إلى مركز لعلاج المرضى.
وبدأ عدد المرضى الذين تعالجهم طواقم أطباء بلا حدود بالانخفاض... من أكثر من 11,000 مريض أسبوعياً خلال ذروة الوباء، إلى 500 مريض في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
“رأينا الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. وهي تستمر بالارتفاع حتى في المناطق التي نعمل فيها.
لدينا مراكز علاج شبه خاوية، غير أن منظمة الصحة العالمية تفيد بوقوع 200 إلى 300 حالة في المناطق عينها التي نعمل فيها، في المدينة ذاتها”.
في الوقت الذي تقفل فيها منظمة أطباء بلا حدود مراكزها العلاجية المؤقتة، تشير حسابات منظمة الصحة العالمية إلى وجود أكثر من مليون مريض، وهذا لا يبدو أنه ينسجم مع الواقع.
“يقول لنا الجميع بأن الأطباء والممرضين وعمال الصحة لا يريدون للكوليرا أن تنتهي، فإن انتهت لن يحصلوا بعدها على تعويضاتهم ورواتبهم.
ولهذا يستمرون في التبليغ عن وجود حالات. تجد أحدهم يستيقظ كل صباح ويبلغ عن 15 حالة، لكن لا أحد يتحقق من هذا. ما من أحد يذهب للتأكد ما إذا كانت الحالات حقيقية أم لا. إنه نظام جيد”.
يشكل هذا السياق تحدياً يُصعّب على المنظمات غير الحكومية الإشراف على برامجها وإدارتها. فعملية السفر والتنقل ترتبط بحسن نية السلطات وبالتالي فهي محدودة للغاية، ولهذا لا تستطيع أية منظمة تأمين معلومات قيمة حول الأوضاع الإنسانية على مستوى البلاد.
تصدر الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2018 تحذيراً يفيد بأن اليمن على شفا مجاعةٍ من أسوأ المجاعات التي شهدها العالم في العصر الحديث.
وفي مقابلة مع “بي بي سي”، تعرِض صوراً لأطفال هزيلين قبل أن يظهر إعلان رسمي صادر عن الأمم المتحدة يقول: “نتوقع بأن حياة 12 إلى 13 مليون مدني بريء في خطر جراء نقص الغذاء”.
لكن هذا لا يتوافق مع ما يراه أشخاص على غرار تييري على الأرض. “لا يمكنني القول شخصياً بأنني أرى مستويات سوء تغذية تماثل تلك التي رأيتها في إفريقيا ومناطق مثل الصومال،
كما لا توجد بالتأكيد أية عناصر تشير إلى وجود حالة مجاعة، لا. رأيت مجاعتين حقيقيتين، في جنوب السودان والصومال سنة 1992.
وقد كانت الحرب هي السبب في كلتا الحالتين، حيث كان الناس عالقين ومحاصرين. لكن الوضع يختلف في اليمن”.
ورغم أن السلطات تفرض ضرائب كبيرة على الأغذية التي يبيعها المتنفعون من الحرب بأسعار مبالغ بها، رغم كل هذا، لا تزال الأغذية تصل إلى موانئ اليمن.
تعترف أنييس قائلة: “تصورُّنا لليمن مجتزأ للغاية. فنحن في الوقت الراهن المنظمة غير الحكومية الوحيدة المنتشرة على نطاق واسع في البلاد، إذ أن لدينا طواقم محلية ودولية في 11 محافظة، وهذا يمثل حضوراً هائلاً
لكن رغم هذا لا نزال غير قادرين على بناء نظرة تحليلية شاملة أو إعطاء صورة عامة عن الوضع، وهذا ببساطة لأن المعلومات التي تصلنا عن طريق مستشفياتنا محدودة للغاية”.
لكن بغياب أية بدائل أفضل، تبقى المراكز الصحية مصدراً يكشف تدريجياً لمحات عما يجري على أرض الواقع... بعضها مقلق وبعضها الآخر يبعث قليلاً على الأمل.
“كانت هناك تلك الموجة من حالات الملاريا التي أعتبرها غريبة جداً، لأنها وقعت في مناطق جبلية مرتفعة. لا ينبغي أن نجد الملاريا هناك، لأن البعوض لا يطير إلى تلك الارتفاعات”.
تحاول ناتالي معرفة قصة هؤلاء المرضى الذين حيروها... كل هؤلاء اليافعين الذين يأتون من خطوط القتال الواقعة شمالاً
“استغرقوا بعض الوقت ليثقوا بي وبالطاقم، حيث أخبرونا الحقيقة وهي أنهم يافعون جرى تجنيدهم أو انضموا طوعاً للقتال.
هؤلاء هم الصبية الذين أُرسلوا إلى الجبهات للقتال، وأدركوا حين وصلوا إلى هناك الخطأ الذي اقترفوه علماً أن بعضهم لم يكن أمامهم أي خيار آخر أساساً
وكان الطاقم يشخص إصابتهم بالملاريا. ثم يجدون لهم سريراً لقضاء الليلة”.
كانوا يرحلون بحلول صبيحة اليوم التالي. كان أمامهم على الأقل فرصة للفرار من القتال كي لا يضطروا للعودة إلى المستشفى ذاته لاحقاً وقد تثقبت أجسادهم بالأعيرة النارية.
“أحسست بأن ذلك أفضل ما يمكن فعله حقاً. لإنقاذ حياة الناس. فقد أنقذوا على الأرجح حياة المئات والمئات من المراهقين. أجل، كان ذلك أمراً مثيراً للاهتمام لم أشهد له مثيلاً من قبل”.
“إنه واحد من تلك النزاعات التي تعارض فيها المناطق النائية السلطات المركزية. فقد تعرضت المناطق البعيدة عن العاصمة إلى إهمال الحكومة المركزية التي تركتها وحيدة دون مساعدة. فهذه المناطق لا تفيد السلطات المركزية بشيء.. لا نفط فيها ولا أي شيء آخر ذا قيمة”.
كانت المعاملة غير العادلة التي تعرض لها أهل الشمال السبب الرئيسي الذي أطلق شرارة الحرب في اليمن سنة 2015.فبعد توحيد البلاد عام 1990، كان الشمال منطقة مهملة.
كانت خدمات النقل العامة تتداعى، وكان موظفو الدولة الذين يُنقَلون للعمل هناك يعتبرون الأمر بمثابة عقوبة، كما كان الشمال يعاني نقصاً كبيراً في العاملين الطبيين والكوادر التدريسية.
أدت هذه المظالم إلى اندلاع أول تمرد بين عامي 2004 و2010، حيث شهدت تلك الفترة اشتباكات متكررة بين الحوثيين والحكومة.
وفي أعقاب ذلك التمرد وأحداث الربيع العربي، اندلعت الحرب في اليمن سنة 2015. وهي منذ ذلك الحين تتصاعد وتؤدي إلى تفاقم زعزعة استقرار النسيج الاجتماعي في اليمن.
“أعتبر غياب العدل مشكلة جوهرية وسبباً جذرياً لجميع المشاكل الأخرى. فلا عدالة إلا في أشكالها القبلية التي تأتي في صيغة معقدة جداً ولا تُسيّر الأمور بالشكل المطلوب في حالات الحرب.
تتطلب مناقشات مطولة لا تحصى تشارك فيها مختلف المجموعات القبلية بغرض تسوية النزاعات التي قد تتمحور حول حمار أو بقرة أو زواج ملغى على سبيل المثال.
لكنها تكون مضنية ومعقدة حين تندلع الحرب.
وهذه التعقيدات التي يتسم بها نظام العدالة القبلي الرسمي تحل محل المنهجيات الأبسط بكثير التي يرتكز عليها النظام العرفي.
فالأسلحة منتشرة في كل مكان، كما أن غياب الأمن يجعل من إمكانية الوصول إلى بعض المناطق أمراً مستحيلاً. ففي مدينة عدن على سبيل المثال، يرى غسان مدى انتشار الأسلحة.
“ما أذكره في عدن هو أنه لو امتلكت 10,000 دولار لاستطعت تشكيل ميليشيا خاصة بك تضم أربعة رجال مسلحين يتربعون في مؤخرة شاحنة صغيرة. بإمكانك استئجارهم لمدة شهر وكسب بعض النقود.
حين وصلت إلى هنا رأيتهم في كل مكان. سيارات بيك أب تحمل رجالاً مسلحين وتتجول في أنحاء المدينة. والغريب في الأمر أن لا أحد يعلم من ينتمي إلى من... لا أحد يعرف.
أما بخصوص حضور المسلحين، فأعتقد أن الوضع قد تحسن منذ أن كنت هناك. فالمدينة قد باتت أكثر تنظيماً بعض الشيء، إلا أنها لا تزال في فوضى عارمة. فهي برأيي مدينة في حالة حرب أهلية”.
اختفى في عدن كل ما هو طبيعي رويداً رويداً. ففي خضم الفوضى السياسية، ازدهر المجرمون الذين سرعان ما استغلوا فشل حكم القانون. لكنهم ودون شك لم يظهروا فجأة حين اندلعت الحرب التي أدت بدورها إلى فراغ.
“ثمة الكثير من العصابات الإجرامية والأنشطة غير المشروعة. حتى قبل الحرب، كان عمل مستشفانا يتلخص بشكل رئيسي في علاج المجرمين وضحاياهم،
، وهذا لم يتغير. فالمستشفيات الأخرى لا تريدهم. والتعامل مع الأمر غير مريح.
نتلقى التهديدات لأن أصدقاء المجرم الموجود في المستشفى أو أبناء عائلته من الرجال يريدون إخراجه أو حمايته وسيفعلون ما يلزم لذلك لأنهم يعتقدون أن الشرطة أو الجيش سيأتون لقتله.
أو أن أسرة شخص قُتل على يده تسعى للانتقام منه وتأتي إلى المستشفى لقتله. هذا أمر يحدث وقد حدث فعلاً مرات كثيرة”.
هذا يفسر حراس الأمن الذي يقفون بمظهرهم المهيب على بوابة المستشفى القائم في عدن. ففي القاعة الكبيرة التي تمثل نقطة الاستقبال الأولى للمرضى، يتعين على الجميع ترك أسلحتهم في خزنات آمنة ذات أحجام مختلفة حسب نوع السلاح
مسدساً أم بندقية روسية أم حتى سلاحاً أكبر من ذلك.وهذا إجراء احترازي بسيط إنما ضروري لمستشفى يقع وسط عدن ويقدم العلاج للجرحى من كافة الأطراف،
من مدنيين وجنود تابعين للتحالف وكذلك للمتعاطفين مع الحوثيين وأفراد في تنظيم القاعدة. إذ لا يستبعد هناك أن نشهد تصفية حسابات أو أوضاعاً تخرج عن السيطرة.
“كان هناك شاب يريد الدخول لرؤية أخيه. أخبره الفريق بأن هذا ممنوع لأنه خارج أوقات الزيارة.
ولهذا قرر إخراج قنبلة يدوية من جيبه وسحب مسمارها وتهديد الحراس الموجودين عند البوابة. كان سيفجرها.
لكن الأمر لم يكن بالجديد على أحد الحراس الذي انتشل القنبلة من يد الشاب وأعاد مسمارها وأبقاها بحوزته.
اتصلنا بعدها بالأمن كي يأتوا ويأخذوا الشاب وقنبلته”.
في مدينة يستشري فيها الإجرام والعنف، غالباً ما يكون المستشفى على علم بالمتفجرات الموجودة على مقربة منه. كان بيرنارد يعمل ذات مرة في وحدة العناية المركزة حين سمع صوتاً عالياً تلاه اهتزاز بسيط.
“اليمنيون الذين كانوا برفقتي أكثر اعتياداً على الأمر، وقالوا ’آه، لقد انفجرت قنبلة‘... بُعيد ذلك بدأ الجرحى يتدفقون بأعداد كبيرة.
لست متأكداً، لكن جاءنا أكثر من 100 شخص، ربما 130. أعتقد إن لم تخنّي الذاكرة بأن الانفجار أودى بحياة حوالي 50 شخصاً”.
عادةً ما يعلن صوت الجرس عن تدفق عدد كبير من الجرحى. لكن كان الجميع متنبهين هذه المرة وكانوا في طريقهم إلى مواقعهم،
متبعين بروتوكول الطوارئ الذي لا يزال أمراً معتاداً في مدينة أضحت أسيرة لهذه الحرب.
يبدو أنه ما من وسيلة لوقف الحرب التي ما برحت تفرق اليمنيين على مدى خمس سنوات. أما الناس، فليس أمامهم من مهرب.
“قد لا تتعرض للقصف بشكل مباشر، لكنك ربما لا تقدر على تحمل كلفة الطعام. قد لا يكون في وسعك استئجار بيت تعيش فيه.
أصبح زواج الناس المقيمين هنا في وضعية الانتظار. عائلاتهم في وضعية الانتظار. حياتهم في وضعية الانتظار. لكن مضت أربع سنوات، وليس في وسعهم الاستمرار هكذا... في وضعية الانتظار”.
أما إلى العمق في الشمال، على بعد كيلومترات معدودة عن الحدود السعودية، تقبع قرية حيدان التي تحتضنها الجبال
عانت هذه القرية ضربات جوية لا تعد ولا تحصى وهي التي تقع في قلب المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون. قضى سكانها المرعوبون وقتاً طويلاً مختبئين في الكهوف التي لا تؤمن لهم حماية أفضل بكثير.
“وقعت تلك الحادثة حين تعرض كهف في القرية المجاورة للقصف، وحسبما فهمت فقد ألقيت القنبلة عند مدخله.
ولهذا فإن قوة انفجارها امتدت إلى داخل الكهف وأدت إلى مقتل الناس... كل من كان في الكهف. لا أعلم أين وقع هذا وكم عدد الناس الذين كانوا في الداخل،
لكن جيراننا في البيت المجاور أحضروا طفلة صغيرة من هناك. قالوا بأنها الناجية الوحيدة لأسرتها”.
الجرح الذي في جبهتها ليس خطيراً، لكن كيف ستكون حياتها بعد هذا؟ يشرح الجيران لناتالي ظروف المعيشة المحزنة داخل الكهوف.
“لا يسعك فعل أي شيء. المكان مظلم. تنام حين تستطيع إلى ذلك سبيلاً، ثم تحاول الخروج والعودة إلى بيتك لتأكل إن استطعت. المكان رطب وبارد وليس آمناً حتى.
وقالت الأسرة التي أحضرت الطفلة: “علينا أن نعود إلى منزلهم لأنه لا جدوى من العيش في الكهوف. ونحن كذلك قد نعود إلى لنعيش في بيتنا ونرى ما ستؤول إليه الأمور”.
تعود الطفلة الصغيرة في صباح اليوم التالي دون أسرتها، برفقة أناس لا تعرفهم.
“وتساءلتُ في نفسي.. كم من أسرة تفككت كهذه وما الذي كان يجري وراء الكواليس. فحين تذهب إلى مناطق النزاعات تكون مدركاً لهول العنف القائم فيها، وحينها، حتى العنف المنزلي يصبح أمراً معقداً في ظل الضغوط الكبيرة التي تعيشها العائلات والتي يعيشها المجتمع. ومن ناحية بسبب الضغوط التي تحدث في المجتمع.
“لا تعلمُ أي شيء عنهم. ليس لديك الوقت لتحاول معرفة ما جرى لهم. يتلخص دورك في إصلاح الأذى البدني الواضح ومن ثم تركهم وشأنهم، وهذا تقريباً كل ما نفعله”.






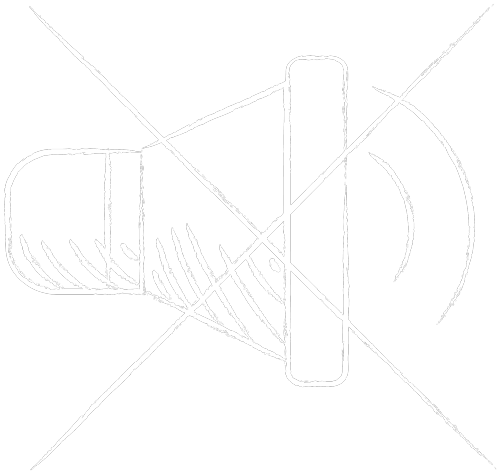









 انقر هناك إن كنت ترغب بالاستماع فقط للبودكاست
انقر هناك إن كنت ترغب بالاستماع فقط للبودكاست  انقر هنا لكتم الصوت ومواصلة القراءة
انقر هنا لكتم الصوت ومواصلة القراءة  توقف وتابع الاستماع
توقف وتابع الاستماع